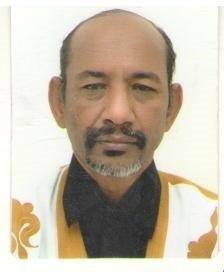 المتتبع الآن للشأن الموريتاني وتفاعلاته الداخلية والإقليمية والدولية، يتبدى له بوضوح أنه أمام مشهد عبثي، يسير على غير هدى.. بلد يسير وكأنه مغمض العينين، بلا ربان، يندفع "اضطرارا أو اختيارا" نحو حافة منحدر، يجعل العقلاء يحبسون أنفاسهم جزعا منه وخوفا من مصير يرونه ماثلا ونتيجة
المتتبع الآن للشأن الموريتاني وتفاعلاته الداخلية والإقليمية والدولية، يتبدى له بوضوح أنه أمام مشهد عبثي، يسير على غير هدى.. بلد يسير وكأنه مغمض العينين، بلا ربان، يندفع "اضطرارا أو اختيارا" نحو حافة منحدر، يجعل العقلاء يحبسون أنفاسهم جزعا منه وخوفا من مصير يرونه ماثلا ونتيجة
حتمية لذاك المسار.. ثم يتفرمل المركب ذاتيا عند نقطة الانزلاق المحتوم تلك، لتعاود السفينة دورتها.. وهكذا دواليك.. زمن دائري وتجربة سيزيفية مملة الإخراج والعرض.
سلطة شكل "حوار دكار" طوق نجاة لها، وصارت لا تعرف من الشراكة في الوطن، سوى كلمة "الحوار"..لكنه حوار يستبطن الإلغاء.. يدعو له الرئيس علنا "خونة البلاد" ويسعى لتحديد نتائجه قبل انطلاقه.. حوار "استرتيجي" مكرس لحاجات ظرفية، لا يبحث عن حل لمعضلة الحكامة ولا يسعى لتحديد معالم شكل الحكم، ولا يضيف لبنة لصالح استيعاب المعضلات المؤجلة دوما من طرف "نخب" وأنظمة أفسدت غالبيتها وبددت وفوتت فرصا نادرة على بلد لا زالت مضامين وأسس دستوره مؤجلة التطبيق.
حوار كان أولى به أن يكون بين "موالاة" مفككة، متناحرة، تشعر بالضياع والتيه والخذلان.. دشن الشيوخ واجهة عصيانها ويلوح النواب اليوم همسا بالدخول في تجاذبات هذا "التدافع من أجل الإستئثار"(وليس الإيثار)، كرد فعل على حتمية "الحل" وضرورات " الحوار" العبثي، الذي لا يعكس اعترافا بالآخر أو رغبة في الشراكة الوطنية أو تغييرا يستجيب لمتطلبات المرحلة.. حوار يؤطره واقع سياسي، يتسم بالتكلس والارتجالية وضبابية الصورة بشكل غير مسبوق، الشيء الذي وضع حاضر ومستقبل البلاد في خانة المجهول.
تجارة الوهم
قد لا أبالغ إذا وصفت هذا البلد، بأنه بلد الأوهام بدون منازع، فعلاقة المنتخبين فيه بناخبيهم، مجرد وعود عرقوبية، والثقافة فيه تقتات على الأوهام، يهلل مواطنوه للتاريخ المبني على الأساطير ويجلدون أي باحث جاد، يسعى لتنقيته من أوهام الخوارق وحكايات الجدات.. لذا نجد المختص في الرياضات على رأس المشتغلين بالتاريخ، الذي أصبح " السلعة الثقافية" الأولى ومصدر النجومية.. يتصدى لمعضلاته الفيزيائي والفيسيولجي وما شاكلهما.. تدور "بحوثه" حول "تاريخ الأجداد، وفقا لحكايات الجدات".. تاريخ تعطى الصدارة فيه لمفاخر الأجداد، على حساب مصير الأحفاد وواقع التنمية وجوهرية بناء الإنسان وترسيخ علاقة منصفة بين الوطن والمواطن.
فالسلط المتعاقبة والحالية، تشكل أهم مصدر لتكريس الوهم.. تقول شيئا وتعمل عكسه، تجند أبواقها وتستعين ببيادقها وسدنتها، من أجل تشويه الوعي وترسيخ الصورة المعكوسة في أذهان العامة والخاصة.. المواطن يعلن موقفا ويضمر نقيضه.. جرائم "الخبراء" و"الفنيين" الوهميين، أصبحت القاعدة.. ومع ذلك يبقى الخبير خبيرا والكاتب كاتب والفني فنيا والمثقف مثقفا والسياسي سياسيا والصحفي صحفيا.. حتى ولو ثبت بالدليل أنهم جميعهم من فصيلة الأميين الفاشلين.. فلا أحد يهتم ولا آخر يرفع الصوت ضد موجة الوهم هاته، التي بشرت بتنمية وهمية وبساسة وهميين ووطنيين وهميين ورجال دين وهميين...إلخ.
فبفعل هذا الوهم كرس دستورنا الأول (المدبج من وراء البحار) وجود قومية وهمية (هي البنبارا) ووفاء لنفس المنطق، يكرس دستورنا الحالي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، ليكون التطبيق دونية لها معلنة وقصورا مخل، يستوجبان "الاستنجاد باللغة الفرنسية بديلا عنها.. بها توقع الاتفاقات والمعاهدات وبها يحدد لربات البيوت كم استهلاكهن من الماء والكهرباء..إلخ.
صعاليك قومياتنا وشرائحنا يحددون "خياراتهم" وترهاتهم على حساب المجموعة الوطنية.. ولا أحد يناقش أو يناظر أو يرد.. حتى صدق كل طرف أطروحاته الوهمية وانزوى في عالمه الافتراضي، فصرنا نعيش جميعا في عالم اللامعقول..لأننا ببساطة في بلد يقتات شعبه على الأوهام.. ويسير بطريقة لا معيارية.. ليست له ثوابت وطنية ولا محددات مرجعية.. يتساوى فيه الشيء ونقيضه.. تسير شؤونه بطريقة مقلوبة ومستفزة.
كيف تدار الحلبة؟
في هذا المشهد المشبع باللامعقول، والذي تتصدره "خلطة" تقليدية، تتمثل في جهاز الدولة وشبكة المصالح ومراكز التأثير الإقليمية والدولية وجوقة القبائل ونخب المكاسب الخاصة، فإننا نلاحظ ظهور مناخ قاتم جديد أفرزته بوادر مطلبية عرقية وشرائحية وفئوية، شكلت جوابا على رحلة التيه وزيف شعارات الدولة الوطنية ومسلكيات النخب العسكرية وذيولها المدنية وسماسرتها المتغلغلين في تمفصلات الجسم الوطني.. جميعهم قد وحدتهم الرغبة في الإستئثار بالموارد والمناصب ومظاهر الجاه المتحول بسرعة البرق..كشكول يرتعد أمام مطالب تريد الحل، معتكفا في "محراب" الدوائر الغربية، ذلا وجبنا، راكعا – بافتخار- تحت أرجل مؤسسات التمويل الاستعمارية، لذا تحولوا جميعهم إلى أرقاء للمناصب وفتات الامتيازات والمكاسب الشخصية، فأصبح الوطن بلا بواكي، وتحولت عامة الشعب إلى مجرد رقم صفري، يستغل في المعادلات الكرنفالية.. يحرك وفقا لمنطق فولوكلوري، يتصف بتعدد الأقنعة ويكرس أقبح نماذج للمكياج.
فتحولت الدولة في ظل هذا المشهد إلى بورصة للمستفيدين من كل القوميات والشرائح والجهات والأعمار وانحسر دورها في المحافظة على تعليم، يكرس الأمية والتبشير بصحة تستزف الموارد لصالح دول في الإقليم، وأمن يكتفي بالبحث عن ريع مخالفات السيارات ليلا ونهارا ويتحاشى المرور بعد الظلام في الشوارع الداخلية للأحياء الشعبية.
ينضاف إلى ذلك كله وضع اقتصادي هش، تؤدي "خططه" لتفقير الشعب وإغناء عناصر جوقة الحكم (عبر الحقب وبكل الأسماء).
هشاشة وتناقض وتذبذب وغياب للمساءلة، كرسوا الشعار الفرعوني: "أليس لي ملك مصر؟".. دفعوا بالكثيرين إلى امتطاء مركب القومية واللون والعرق والشريحة والجهة والقبيلة، والمظلومية اللانهائية، بغية الحصول على جزء من الكعكة ، ومن أجل أن يصبح هو (وليسوا هم) من فئة "المهمين"، مستغلا انتهازية وبراغماتية الناهبين والمتمالئيين معهم ضد مصالح البلاد والعباد.. لذا أصبحنا أمام مشهد يتحرك على إيقاع الخارج أكثر من صوت الداخل، تنهب موارده من طرف ثلاثي "الكبار" والوسطاء وجوقة المناسبات، التي تتفاعل داخلها العرائض المطلبية والمظالم العلنية ولافتات الواجهات القبلية، الشيء الذي حول البلد إلى ملك خصوصي.. ارتبط فيه تحقيق الطموحات الشخصية بإجادة الرقص على الموسيقى العسكرية وإتقان التكيف مع لغة "البيان رقم1".
مشهد يجعلك تعتقد أن الشعب قد حدد "خياراته"- بفعل لا وعيه وانتهازية "نخبته"- من خلال لا مبالاته، التي جعلت من "حرامية البلد، هم حماته".. لذا أصبحت الدولة العميقة هي "الوطن" وصارت الكفاءة سبة وتحول الوطن إلى سجن كبير، يتطلع كل شخص فيه إلى مغادرته بدون رجعة.. الكل فيه ظالم ومظلوم في نفس الوقت.. غابت النظرة المستقبلية فيه عن ساكنته و"ساسته".
فقد أدت هموم الحاضر وتعقيداته -التى ألقت بظلالها بقوة على المشهد الحالي- إلى انكفاء النخبتين المدرسية والقبلية باتجاه مظاهر ما قبل الدولة واللجوء إلى تاريخ أسطوري لا يسمن ولا يغني من جوع..أصبح عنوانا ل"التقدم" و"التطوير" و"التشييد" فكان الإنجاز وهما لارتكازه على منظومة من الأوهام، مثلت الاستجابة الوحيدة لواقع ضاغط، لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير.. فالأخطاء كبيرة والخلل شامل ومطالب الإصلاح لم تعد تحتمل التسويف.
هذا يركب القبيلة وذاك الفئة أو الإثنية.. وآخر يرى في التقرب إلى مستعمر الأمس سندا تفوق فاعليته بقية المطايا، قربانه التغنى بأمجاد خصم وطنه والمبالغة في تحقير رموز دولته.
ولعل أغرب ما في الأمر: أن لا أحد مصنف اليوم كوطني.. فالناس ما بين موصوف - دون تجريم للأسف- بالولاء لهذا البلد الجار أو تلك الدوائر ، وبين مدع للاضطهاد في بلده، يستجدي الحماية من الدوائر الاستعمارية، متناسيا أن هذا الغرب ما تدخل إلا ليفرق ويسود.
فأضحت الفئة التي توالي الأجهزة الأمنية، هي الوحيدة اليوم، التي تدعي صفة الوطنية.. هذه الوطنية التي عرتها أفاعيل الدولة العميقة في دول الربيع، التي كشفت زيف ادعاءاتها للوطنية، وبرهنت تلك القوى المضادة على أنها أهم معول ضد الإصلاح، وقد تكون هي الأخطر من بين عناصر الجوقة الحاكمة، ما لم يوجد من يعي الدرس، فيلجمها ويقلل من غلوائها.
وبما أننا أمام تجربتين في الحكم(مدنية وعسكرية)، هما من أوصلا البلاد لما هي فيه من خير أوشر، فإننا على العموم وإنصافا للجميع، نعترف أنهما قد أوصلتا البلاد إلى وضع تستحيل مقارنته مع مرحلة الاستقلال وظرفية إعلان الدولة الوطنية، سواء من حيث عدد الأطر أو نوعية الكفاءات وعمق التجربة أو البنية التحتية ومستوى الوعي داخل المجموعة الوطنية..إلا أن هذا النمو المادي والتنوع في مصادر الدخل وكل ما أنجز، طيلة ال56 سنة (هي تقريبا عمر الدولة الموريتانية)، قد حمل معه تعقيدات ومعضلات، ظلت مؤجلة الحل، لتتحول - كأي مرض- إلى حالة متقدمة خلفت أمراضا أخرى، تبدو اليوم وكأنها مستعصية على الحل .. بفعل تبني شعار: "أنا ومن بعدي الطوفان".
ورغم ما قيل وما قد يقال عن المرحلة الإنتقالية(2005- 2007)، فإنها مثلت محاولة للإصلاح، سرعانما تم الإجهاز على إفرازاتها، فحرمت البلاد من تحقيق تجربة متكاملة، قابلة للتقييم والحكم الموضوعي.
- البعض رآ في المرحلة الانتقالية: مجرد محاولة لمكيجة واقع لم يعد قابلا للاستمرار.. كان يهدد بنية الدولة وديمومتها، مؤكدا أن الإصلاح يستحيل أن يصنعه سدنة الفساد وحماته الأساسيون .
- البعض الآخر رآ في تلك التجربة: تحريكا للمياه الراكدة على الأقل ومحاولة قابلة لأن يبنى عليها والسير بالبلاد وفقا لها نحو نهج يصون البلد ويحقق السلم الاجتماعي ويرسخ مستوى من الاستقرار، تحتاجه البلاد، إثر رحلة طويلة من تيه الانقلابات المدمرة.
أين المفر؟
أمام تجارب في الحكم، لا زالت مثار جدل، ويصعب قبول تقييم موضوعي لها اليوم، لأن كل طرف لا زال يتغني بليلاه ويعتقد أن تجربته هي الأفضل وأنه أنجز ما لم يستطعه الأوائل.. فإننا، نجد ثابتا واحدا ميز هذه الأنظمة وطبع مواقف نخب التزلف:( فكلما انقلب عسكري على شريكه السابق في الحكم لعن مرحلته واستهل التاريخ الوطني بلحظة دخوله للقصر الرمادي.. كما أن جوقة التصفيق هي الأخرى، ظلت تقف مع "المنتصر"، تقدس الحاضر وتلعن الغائب المزاح بقوة السلاح).
فكانت النتيجة أن فقد الناس الثقة في قادتهم ونخبهم وحتى مستقبلهم، وصار الكل شريكا في رحلة الضياع الشامل، شعارهم جميعا: خذ خير"دولتهم"، فهي لم تعد صالحة لأن تبقى وطنا.
آخرون فضلوا الانتظار والسعي لفظيا لإصلاح ما أفسده المفسدون الحاليون والسابقون.. لكن عيبهم أنهم يركزون على الأماني أكثر من استعدادهم لدفع الثمن وتصحيح الخلل القاتل.
لذا يجب أن نتعامل مع المشهد الوطني- رغم تعقيداته وتشعباته- بمستوى من الانتقائية المتسمة بالتدرج، على مستوى الخطط والكادر.. فلم تعد لدينا رفاهية الإختيار وليست تجاربنا في الماضي صالحة للإحتذاء.
مالحل؟
نحن أما واقع، تزيده معيارية التقدم والـتأخر إشكالا.. واقع يتفق الجميع على أنه عصي على التصنيف والتصديق، جعل البلاد – إن لم تكن في غيبوبة، فهي على الأقل ليست على ما يرام.. واقع لا يمكن إعادة إنتاجه ويخجل كل منصف أن يدافع عنه، لذا لا تشكل مسايرته حلا قطعا.. كما أن تجارب الشعوب بينت أن المحاصصة السياسية، والفئوية والعرقية، هي الشر بعينه.
* فقد أصبح لزاما على المهتمين بالشأن العام أن يؤسسوا قواعد صارمة للتناوب السلمي على السلطة، تسد الباب أمام مغامري البلاغ رقم1 وانتهازيي التفرقة.. أسس تبعث الأمل وتسمح بمستوى من الاستقرار، يؤسس لتنمية جادة وواعية ومسؤولة.
* إكراها سايكس بيكو، لا زالت تفعل فعلها، وبالتالي فرغم الواقع المأزوم، الذي يعيشه الإقليم المحيط بالبلد، فلا زالت عملية الاندماج المغاربي دونها جبال من الموانع، كما أن التكامل الإفريقي، تكبله الاتفاقيات الثنائية مع الدولة المستعمرة وفضائها الغربي والإقليمي.. لذا لا بد من ابتكار آلية جديدة، تعتمد على الكفاءة وتستعين بالإبداع.. ترشد الموارد وتصونها من النهب والتلاعب.
* السيبة جربناها في السابق، ولا زالت مراراتها حاضرة في ذاكرة الجميع، وهي اليوم أشد فتكا وأعظم ضررا، لتوفر أدوات التدمير وجاهزية سماسرة الحروب.. سنصبح في ظلها – لا قدر الله- مجرد بيادق تخدم الخارج وسنتحول جميعا وفقها إلى عبيد للآخر، قد يتطلب منا التخلص من نير عبودية العصر قرونا عديدة.
* فمن مفارقات المرحلة: أن الفئات والشرائح، المستفيدة من قيام الدولة، هي اليوم أشرس عدو لها.. يعملون جميعهم على تقويضها وتشويه سمعتها بكل الوسائل والسبل، دون أن يدركوا أنهم سيصبحون أول ضحايا تدميرها وسيكنسون عند ما يسود قانون الغاب.
* الإنقلابات العسكرية هي الأخرى اتضح إفلاسها وأصبح واضحا أنها هي الأخطر على حاضر البلاد ومستقبلها.. فقد تكشف بالدليل تعطش العسكر للسلطة، وبرهنوا أن تدخلاتهم السابقة ليست بدافع "الإنقاذ" ولا "الاصلاح" أو "العدالة والديمقراطية" و"التصحيح".. وإنما هي "مغامرة" لخدمة جيوبهم وبطونهم وترقية ذويهم، ليس إلا.
كما أنه قد لا تسلم الجرة دائما خلال أية محاولة انقلابية مستقبلية، لدوافع يذكيها التخندق القبلي والاثني والشرائحي والجهوي والمصلحي.
* الوقوف بقوة أمام مهزلة تحويل البلاد إلى مخبر تجارب في الحكم لكل مغامر امتطى دبابة، أو انتهازي تسلق منصبا.. فذاك خيار، يكتسي طابع الاستعجال والجدية.. فتجارب الماضي قد أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية، لذا تجب القطيعة معها.. والبحث عوضا عنها عن صيغة تستند إلى خبرة الخبراء وتجارب الشعوب المماثلة وتبني سياسة ترى في الإنسان وسيلة وغاية.
* الجمع بين المركزية والجهوية وخلق توازن بين سطوة المركز وانتهازية النخب المحلية..وتشييد دولة القانون والفرص المتساوية، نهجا في الحكم، بعيدا عن المحاصصة القبلية (أولا) والاثنية والشرائحية (ثانيا).
*************
إن موريتانيا اليوم تقف أمام منحدر صعب، لا يشي به بالضرورة مظهرها، لكنه مستبطن في مختلف أنسجة كيانها ويعكسه بجلاء حجم المعضلات الضاغطة وتحكم نخب الفساد والإفساد فيها وانهيار المؤسسات.. تحديات تدفع بها في اتجاهات تتسم بالتذبذب وضبابية الهدف، بفعل فشل الدولة في تقديم نفسها بشكل مرضي ومقبول وجنوح الطامحين من "نخبتها" إلى مراحل ما قبل الدولة، لاعتقادهم أنها بلسم ومنقذ لهم من واقع خانق وظالم.. لذا فإن البلاد اليوم بحاجة ماسة إلى عقلائها، المستعدين لأن يصبحوا رجال إطفاء، لديهم إرادة إخماد حرائق الفتنة وفرملة تيه الضياع، متسلحين برؤية تجعل من الكفاءة والوطنية معيارا ومن المصلحة العليا نهجا..فالمنحدر صعب والذئاب متربصة، وكنوز الأرض تغري القريب قبل البعيد..
فهذا وطن، احتضن ماضي السلف وبه سيتحدد مصير الخلف..من الحكمة أن لا نضيعه.












